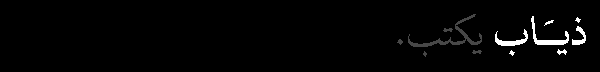جريمة حدثت في باريس

“قتل المدنيين جريمة لا علاقة لها بأي جريمة أخرى ارتكبها غيرهم، حتى لو كان القاتل نفسه ضحية هذه الجرائم الأخرى. وغالباً ما لا تربطه بها سوى علاقة نفسية أو معنوية”، يقول الدكتور عزمي بشارة في مقالته بعد أحداث باريس الأخيرة. ومن قرأ مقالته يخلص إلى أنه رغم رفضه النهائي للسردية الغربية؛ إلا أنه يصرّ على رفض الجريمة “سلّم قيم أخلاقية”. نعم وبوضوح، وقبل أي نقاش حول طبيعة وتبعات ما حدث، أن نرفض الجريمة.
هذا ما نريد أن نؤكد عليه. أن لا يذهب بنا المدى في النقاش إلى الاستخفاف بالدماء. رغم ما حصل، هذا لا يبرر الجريمة بحال، ولا يخلق حالة من التسالم مع مشهد الموت، ولا يمنح -هذا الاختلاف- الشرور وسمًا أخلاقيًا بأي درجة، ولا يجيز فتح الباب أمام التذابح، ولا يشرعن العاطفة المجنونة بحال متجاوزةً كل ما له صلة بالإنسانية والأخلاق والمنطق بما فيها منطق الدولة والقانون، إلى الجريمة.
لسان حال النقاشات -إن جاز تسميتها كذلك- التي تبعت الاعتداء ربما لا تقل عن الحادثة مأساة: “كلكم مخطئون، وفي مرحلة متقدمة: حمقى، لم يقل أحد منكم في ما حصل ما يجب أن يقال، اسمعوا منّي..”. لا يبدو أن أحدًا يريد أن يقف للحظة في المنتصف، و(يقف) هنا لا تعني اتخاذ موقف محايد بالضرورة، بل تعني أن يقف، فقط، أن يفكر بموضوعية تجاه كل ما قيل، من خصومه وقبل أقرانه، أن يسمع برويّه ويخلُص إلى موقف صلب و يلتزم بعد ذلك المربع الذي يراه.
الغريب، بل والمفزع لأتحرى الدقَّة، أن الأغلبية، وهنا أتحدث عن المثقفين والنخب، ممن سارعوا في إصدار موقفهم حول ما حدث (ومن لم يسارع؟)، تمترسوا مباشرة خلف حواجزهم، في معسكراتهم، واتخذوا من الحادثة غطاء لرشق خصومهم دون أن تكون الحادثة حقيقة في مركز اهتمامهم، حتى أولئك الذين حاولوا التفرُّد، انصهروا آخِرًا في المجموع، وفي الرمز، أو تواروا خلف تلميحات لا معنى لها خشية اتهامهم بالتفريط بالالتزمات الضمنية لصالح الفريق الذي يلتحقون به.
باعتقادي أن اعتداء باريس ليس حدثا عاديًا، مع ما صاحبه من زخم عالمي؟ مع نقاط الإلتقاء الكثيرة هذه؟ لا ليس حدثًا عاديًا، بل كرنفال مفاهيمي بامتياز، وفرصة تتيح للجميع عقد المراجعات والمقاربات وإعادة الحسابات والتأمل من جديد في الكثير من الرؤى والأطروحات التي تبنّوها، الأخلاقية أولاً، والسياسية والدينية. أولئك الذين يصرّون أن حادثة كهذه -أكرر: بهذا الزخم- حدثت بفرنسا لا تعنيهم؛ إنما يضيّعون على أنفسهم هذه الفرصة المثالية.
ليس غريبًا، ونحن نعيش في العصر الذهبي “للدولة الإسلامية” وتفرعاتها، الإحياء الجديد للفكر الوهابي في الألفية الحالية، أن تحدث حادثة كهذه، وما سبقها وما يلحق بها هو ضمنٌ لهذا السياق، وأعتقد أن حرس هذا الإحياء الجديد يصرّون دائما على إثبات هذا الواقع، ويردون بتطبيقات صارمة وبجرأة فاقعة فاتورتها الدم على من يزعمون غير ذلك، وأعني تلك التكهنات التي صاحبت الاعتداء، والتي أدمنّا سماعها كل مرة، عن أن الموساد هو من يقف وراء ذلك، أو السي آي إيه، أو حتى الحرس البابوي بالفاتيكان، أو كلهم مجتمعين، لا يهم، هؤلاء الذين يحترفون الهروب لن يقفوا على نتيجة، الذين يستدعون “المؤامرة” دائما وكردة فعل كلاسيكية، إنما يتشرّبون العجز ويجودون على العقل الشعبي بالهراء ويوسعون من بقعة الزيت في الماء الملوث.
وعلى كل حال، وجدنا أن القاعدة تبنّت ما حدث.
يجدر بنا أن نقول أن سؤال “هل المسلمين مسؤولون عما حدث؟” هو مغالطة، وسؤالٌ معلول قبل أن نجيب عليه، وإذا أردنا أن نتسائل -إن جاز- فنقول “هل يجب أن يفعل المسلمون شيء؟” إذا ما اعتبرنا الدلالات الدينية في الحادثة. معلولية السؤال الأول أنه غيَّب عنصريْ (الزمان والمكان)، وحوّله إلى سؤال استهلاكي تدوِّره أجهزة الإعلام والصحافة، ولا أعتقد أن مثقفا سيتعامل معه -وهو بهذه الصيغة- بشكل جاد. أعتقد أن دور المثقف هنا أن يعيد صياغة الأسئلة قبل أن يجيب.
وللجواب عن معلولية هذا السؤال لدينا مستويان، مستوى الفرد ومستوى الجماعة، مستوى عموم الناس ومستوى التمثيل، وأعني الزعامات والمؤسسات والهيئات. وداخل مستوى الفرد/عموم الناس، نتجاوز البحث في عامل الزمان إلى المكان، لأننا نتحدث عن حادثة واقعة قبل أسبوع، نتساءل ونحن نتحدث مع أولئك عن عنصر المكان: هل يجوز أن نُحمِّل (الفرد) المسلم في شمال روسيا بوِزر (الفرد) المسلم في جنوب البرازيل؟ وهل يجوز أن نُحمِّلهما معًا وِزر مسلم بفرنسا؟ يقول قائل لربما جمعهم ارتباط تنظيمي؟ بمثل هذا السؤال تسقط المسألة برمتها، لأن نطاق البحث اختلف. ففي الأولى نتكلم عن ارتباط ديني مفتوح ومتأصل في الوجدان وعن نصوص متعدّدة التأويلات، أما الثاني فإننا نتكلم عن تأويل واحد، لا يتحمل الباقون وِزره في تأويله الذي ذهب إليه، فضلاً عن كونه تأويلاً متطرفًا.
لذلك، كل الدعوات التي تدعوا إلى محاسبة المسلمين -كل المسلمين- لا تبدو منطقية ابتداءً، وهي كذلك لا مسؤولة وتطرّفٌ مضاد بالضرورة، وفي دوائر معينة منها تبدو فجة وغير أخلاقية وسياسية بالدرجة الأولى.
وتبعًا لذلك لا يلزم المسلمين كأفراد (الاعتذار) عن ما حصل، فليس لهم علاقة عضوية به أصالةً، فلمَ الاعتذار؟! وهذا إذا ما رأينا فإنه يمسّ بشكل مباشر حرية الاعتقاد التي يبشّر بها أولئك الذين يطالبون كافة المسلمين بالاعتذار: “أنت مسلم، أنت إرهابي بالتّبع!”. نتفق مع حرية الأديان بالضرورة، ونعتقد أن ربط المسلمين بالإرهاب ينافي هذه الحرية. تسع المسلم هنا ردة فعل تتجسّد في (التنديد) كما تسع غيره بشكل طبيعي، هذا مقبول، بل أقول أنه يلزم القريبين من دوائر صنع الرأي الشعبي في أوروبا أن يلتزموا هذا الموقف الأخلاقي، التنديد بالجريمة.
ربما هذا يدفعنا إلى التساؤل، هل يحق للفرد المسلم هنا -قبل غيره- محاسبة الرموز والزعامات والمؤسسات المشيخية؟ للإجابة عن هذا السؤال، يجب علينا ابتداءً هنا أن نقول أن الوثوقية التي يذهب إليها المضادون للسردية الغربية فيما يخص (تجريم كافة المسلمين الأفراد)، هذه الوثوقية يجب أن تتواضع عندما نتناقش حول الزعامات وممثلي الجماعات والهيئات الإسلامية.
هل ساهمت هذه الرؤوس في تصدير خطاب عنفي باسم الإسلام؟ نقول بشكل متباين. ليس ثابتًا ذلك بالمطلق. فإذا ما استعرضنا كل المدارس الإسلامية، نجد المتطرف والمتسامح، العقلاني الناظر والحروفي الجامد، نجد أدبيات وتأويلات مختلفة. لكنه موجود، هناك خطاب عنفي يصدر من هذه الرؤوس باسم الإسلام يلتفّ حوله سوادٌ عظيم، هذا الخطاب العُنفي ضد الإسلام نفسه ابتداءً، يتمظهر ذلك في الحروب المذهبية السنية-السنية السنية-الشيعية، مرورًا بالتيارات الفكرية الأخرى، كما حصل في اغتيال “براهمي” و”بلعيد” في تونس و”فودة” بالتسعينات، وانتهاءً بالعنف الخارجي في أوروبا وأمريكا. مهما ذهب بعضهم بعيدًا في إنكار أن ثمة مشكلة، بدوافع ثقافية ربما، فإنه يستهلك عليه الوقت الجهد، ولا يلغي وجودها.
لحصر مصادر هذا الخطاب العنفي سنجد أن الأبرز بينها، والتي تتسيَّد بقية الخطابات، إما تؤصّل للعنف في كتبها وتطبقه، وإن عجزت فإنها تتحيَّن الفرصة لتطبيقه، أو أنها براغماتية تؤصّل له ولا تطبقه لوجود سلطة أقوى منها أو اعتبارات قسرية أو نفعية أخرى، ولكنها متسامحه مع الذين يطبقونه، أو في حال رفضته علانية وافقته سرا أو وافقت بعضه. وأخرى تختلف مع هذه التأصيلات وبالضرورة مع التطبيق أيضا، لكنها تتماهى معه. أي أنها تفترض فيمن يعاديه الشرور، ولسان حالها الأثر عن الإمام علي: “إخواننا بغوا علينا”.
بعيدًا عن التطرق للاعتبارات الاستعمارية والثقافية المؤثرة بالطبع، وداخل الحقل الديني، نجد أن هذا الخطاب العنفي يلقى حضورا داخل الأوساط الشعبية، إلى جانب توظيف السياسي له لقمع الخصوم الخارجين على النسق الذي يرتضيه، وأنا لا أدعو هنا إلى إفراغ الإسلام من نصوصه لإشباع الغرب الشَّرِهْ بحال كما يفعل آخرون، بل أدعو لثورة أخلاقية تصحيحية من الداخل، لأجل الداخل قبل الخارج، تنطلق من العقل مرورًا بالنص إلى العقل مجددًا، تغربل التراث وتصغي للمنطق وتتوسّد الفلسفة وترفع راية الأخلاق. إلا أن هذا يبدو بعيد المنال وسط رائحة الدم، في زمن الاستبداد والثورات والثورات المضادة وتوظيف الدين والتحيُّزات السياسية التي تطغى على افتراض صدق النية وحسن المقصد في هكذا دعوات، إذا ما تذكرنا أن أحدها جرى على لسان فرعون القاهرة.
لا تفاضُل في الجريمة. ما حصل لأولئك الأبرياء جريمة، وما حصل في تاريخ الاستعمار الفرنسي جريمة رغم التفاوت، والتماهي -بكل أشكاله، الخفي والصريح- مع أحد الجريمتين عَوَرٌ أخلاقي، ولا تبرّر إحداهن الأخرى، وهذا الخلط يضر العرب قبل غيرهم، وقوة التنظير في صناعة الفعل، والانطلاق من ردة الفعل عجز، ولا يجب أن نعزِّز من مكانة التطرف والتطرف المضاد الذي فاض بنا قبل غيرنا، ولن يكون هناك حل بالخطاب التحشيدي المبني على العواطف والكثير من التضليل الذي استغله السياسي أحسن استغلال طيلة العقود الماضية ضد الشعوب على مرأى ومسمع.
ما فعله المتطرفون هو فرصة مثلى وامتحان حقيقي للبعد الأخلاقي لدى المثقفين والزعامات ورجال الدين والهيئات والمؤسسات المشيخية المستقلة لترتيب الأوراق من جديد.
في المقابل لم تفهم فرنسا جوهر هذا التعاطف، واستغلته بصورة نفعية بعيدة عن الأخلاق كما هي السياسة، لنشاهد إرهابيًا كنتنياهو يتقدم مسيرة تناهض الإرهاب، وليتبع عدد المجلة المستفز عدد آخر بذات الطريقة في مشهد غير مسؤول. لم يفهم الفرنسوين أن حرية تعبير الآن لم تعد مجرد حرية تعبير، بل تطوّرت لتأخذ منحى جنائيا. لم يستوعبوا هذا التعاطف من المسلمين ضد الجريمة، وسمحوا بتمرير عدد آخر رغم الوضع الاستثنائي الذي تطلّب تدخلها، ليوقعوا المسلمين في حرج؛ بين الجريمة التي أدانوها، وبين الرسومات التي رفضوها.
في نفس السياق نجد في فرنسا تجريما مبدأيًا لمناقشة الهولوكوست مثلاً أو التشكيك فيها فضلاً عن تأييدها باعتبار ذلك “معاداةً للسامية”، كالكوميدي الفرنسي “ديودونيه” الذي لوحق بتهم كهذه وتهم أخرى من ذات النوع رغم شهوده المسيرة المندِّدة.. فكيف يكون التوفيق بين هذا وذاك؟!
كيف يريد الفرنسيون أن يستقبل العرب والمسلمون في أوروبا قبل بقية العالم هذا؟ بالرضا؟ ثم كيف يريدون أن يستقبل المتطرفون منهم هذا؟ بالورود؟ لماذا يخلقون -بهكذا تناقض- الظروف المواءمة ويوجدون المبررات للمتطرفين ليقوموا بفعلتهم؟ هم مسؤولون عن هذا أيضًا بدرجة ما.
الذي أريد أن أقوله أن الجرأة في تشخيص المشكلة وعدم الهروب من شواهدها، وتكامل الرؤية مع هذه الحادثة وحوادث مشابهة أولوية، ولا تعني المداهنة أو الضعف. بل أننا بهذا وعبره نستطيع أن نقول أننا جاهزين لمواجهة أطراف محددة، تعاملنا معها بكبرياء ونضج، ولم نترك لها مجالاً لتتلاعب بمعاييرنا الأخلاقية أو تسخر من ازدواجيتنا إزاء المفاهيم المفصلية أو تستغل الخطاب التحشيدي الرخيص لصالحها.